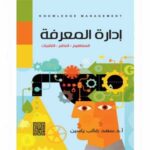المقدمة
أن حقل إدارة المعرفة وهو العلم والتخصص اليافع ينتظر مزيداً من الدراسات الفكرية والأكاديمية والتطبيقية في جميع ميادينه وروافد نهره الممتدة من مجالات الفلسفة ونظريات التعلم إلى نماذج الإدارة الحديثة ونظم وأدوات تكنولوجيا الذكاء الصناعي وتقنيات المعرفة.
وتعبر هذه الحاجة عن نفسها بصورة إشكالية تاريخية في وطننا العزيز والكبير الممتد من الماء في الشرق إلى الماء في الغرب، ذلك لأننا نفتقد إلى دراسات في ميدان إدارة المعرفة ونظم إدارة المعرفة مكتوبة بلغتنا وفي ظل ثقافتنا التي تسائلنا عن الجديد الذي يكون جديداً بحق وليس الجديد الذي يأتي تنويعاً على القديم، قديم فكرنا وتراثنا أو الجديد الذي يأتي ترديداً لنماذج ومداخل ونظريات (الآخر) من دون أي جهد للتبيئة والتحيين، ومن دون أي قدر من المزاوجة الولودة المبدعة بين ما هو أصيل في فكرنا وما هو حديث وجديد في عصرنا.
وأنا لا أدعي أن هذا الكتاب يصل إلى وعي هذه المسألة الإشكالية ولكنه يضيف لبنة جديدة وبلغة غير تقليدية إلى الفكر الإداري في هذا الحقل لأنه يجمع ببساطة بين نظرية إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات. ولأن هذا الكتاب يساهم في الجهود الأكاديمية والفكرية الحثيثة لتكوين إدراك عميق ووعي أصيل بإدارة المعرفة ومشروعات تطبيق برامجها، ونظمها.
إن الإشكالية الحقّة غير المفتعلة والتي تتعالى على النقد هي أننا بحاجة إلى معرفة بإدارة المعرفة، معرفة بنظم إدارة المعرفة وبالتالي فإنّ الأمر لا يقتصر على الكتابة والتأليف والبحث بل أيضاً على تحفيز النظر وتوجيه أنظار الباحثين والمديرين وصانعي القرار إلى أهمية وحيوية حقل نظم إدارة المعرفة.
إن هذا الاستهلال قد يبدو فضلة وزيادة إلا أنه يلامس حقيقة مؤلمة وهي أن معرفتنا بإدارة المعرفة والمهارات الموجودة في هذا الحقل الحديث لا تزال ناقصة، مُبتسّرة وصورية إلى حدٍّ كبير. ولتوضيح هذه المسألة نعود إلى محمد عابد الجابري الذي ذكرنا بأهمية ما قاله أفلاطون في حديث مهم له عن الواقع السياسي العربي وهو حديث منشور في موقعه على شبكة المعلومات العالمية. يقول الجابري نقلاً عن أفلاطون في سياق بحثه عن المعرفة وأنواعها وعلاقتها بالوجود لنفترض أن شجرةً تقع على ضفة نهر، وأنت واقف بجانبها تنظر إلى الماء. في هذه الحالة سترى الشجرة عبارة عن شبح يلتصق بحراك في ماء النهر. ويقول أفلاطون إن هذه الحالة تمثل أدنى درجات معرفة الإنسان بالواقع ولذلك يمكن تسميتها “بالمعرفة الشبح”. ثًمّ لنفترض أنك ابتعدت عن هذه الشجرة وانتقلت إلى الجهة الأخرى من النهر فعلى أية صورة سترى الشجرة؟ إنك ستراها ظلاً جامداً مُرتسِماً على وجه الأرض. وهذه المعرفة هي أرقى من الأولى وبالتالي يمكن تسميتها بالمعرفة الظلية أو (المعرفة الظل). أما إذا واجهت الشجرة ونظرت إليها مباشرة فسوف تراها ماثلة كما هي في وجودها. وهذه المعرفة أرقى من مستويات المعرفة السابقة ويمكن تسميتها بالمعرفة الصورية (المعرفة الصورة). غير أن هذه المعرفة لا تقدّم لنا معرفة حقيقية بالشجرة إلا ما يمكن أن يظهر في الصورة الخارجية وبالتالي فإن المعرفة الصورية لا تمثل حقيقة الشجرة ونموذجها الأمثل. وأخيراً يقودنا أفلاطون إلى استنتاج إلى أن المعرفة الحقّة هي المعرفة الحقيقية، معرفة النموذج والمثال. إذن معرفتنا بإدارة المعرفة وبنظم ومضامين تطبيقاتها هي شبيهة بالمثال الآنف الذكر وبالتالي هي معرفة مُلتبَسة ومجزّءة. ويبقى السؤال المهم قائماً إلى أي نوع من المعرفة تنتمي معرفتنا وفهمنا لحقل نظم إدارة المعرفة. وسيكون الجواب تأسيساً على ما تقدم هو أن فهمنا ومعرفتنا لحقل إدارة المعرفة ستكون تابعة إلى المكان الذي ننظر فيه إلى هذا الحقل. هل ننظر إليه في الماء؟ أم ننظر إلى ظله؟ أم إلى صورته؟ أم نفكر فيه بناءً على ما هو عليه في الواقع متجاوزين إشكالياته وصوره المنطقية (الضمنية) والحسية (الصريحة).
ونقول هنا، إنّ اختيارنا كان ولا يزال لتوليفة إدارة المعرفة بمضامينها الإنسانية والاجتماعية والإدارية والتقنية ناهيك عن علاقاتها الودودة باقتصاديات المعرفة. ومع ذلك، أردنا من هذا الكتاب أن يشرح بصورة مفصّلة أحد الأوجه الرئيسية لإدارة المعرفة ونقصد تكنولوجيا إدارة المعرفة والتي تدعى على نطاق واسع بين الأكاديميين والباحثين والممارسين بنظم إدارة المعرفة. وغايتنا في هذا الاختيار هو السعي نحو تعميق الوعي بإدارة المعرفة ليس من حيث كونها مفاهيم ونظريات وثقافة وإنما أيضاً مشروعات وبرامج لتطوير وتطبيق نظم إدارة المعرفة التي تجسد أرقى حالات التعاضد البنيوي العضوي بين المعرفة وتكنولوجيا المعلومات الذكية.
إن المعرفة غير قابلة للاكتمال مثلما أن التاريخ سجال بلا نهاية ولهذا يأتي كتاب إدارة المعرفة بفصوله السبعة لبنة تُضاف إلى جهود حثيثة ومتواصلة لفهم وتحليل العلاقة بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في أرقى حلقات تطورها. ونحن نعتقد مع ميشيل فوكو بأنه ما من علاقة قوة (وما من علاقة سلطوية) من دون بناء مترابط الحقل من المعرفة، وما من معرفة لا تستلزم ولا تنشئ في الوقت نفسه علاقات قوة وعلاقات سلطة. إن المعرفة قوة، وهي دالة القوة. ونظم إدارة المعرفة هي دالة مجسّدة لفاعلية إدارة المعرفة في المؤسسات العامة وفي منظمات الأعمال الخاصة. ولا نعتقد أن أمامنا أي خيار في عالم اقتصاد المعرفة الجديد سوى النظر في كل حقول المعرفة من اقتصاد وإدارة ونظم وتكنولوجيا ليتسنى لنا دراستها وتحليلها وبالتالي ترتيب أو تغيير أوضاعنا مع احتياجات ومتطلبات هذا العصر وإلا سوف نبقى على هامش الحياة الإنسانية وخارج التاريخ وبدون مستقبل واعد لنا ولأجيالنا.
يقول محمد أركون أن للمعرفة الإنسانية ثلاثة أبعاد: البعد الأسطوري، البعد التاريخي، والبعد الفلسفي. البعد الأول يرتكز على الأسطورة والثاني فهو ذلك الذي يشكله علم التاريخ النقدي والذي يضم علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا التاريخية. أما البعد الثالث فهو ذلك الذي يؤمنّه لنا النقد الفلسفي. وفي الواقع أن هذه المستويات الثلاثة من مستويّات المعرفة تتعايش في جميع الثقافات البشرية.
أما مستوى المعرفة الذي يرتبط بهذا الكتاب فهو المستوى الذي يتعايش مع الثقافة التنظيمية باعتبارها جزءاً حيوياً من الثقافة الإدارية العربية مع التركيز على توليفه المفاهيم، النظم والتقنيات لإدارة المعرفة. التركيز على البعد التقنّي يعود إلى تخصّصنا الدقيق في حقل نظم المعلومات الإدارية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الأعمال، ولأن المعرفة عندنا (إذا كان لنا عِندْ كما يقول الجاحظ) هي ثمرة العقل والنقل، ثمرة التجربة وبذرتها، ونتاج تلاقي الحدس والتصور بالخبرة والممارسة.
والمعرفة هي الطريق إلى الحكمة والحكمة تهدي إلى الحق. “وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين”.
وبعد، فإن كتاب إدارة المعرفة: المفاهيم، النظم، التقنيات سيضم في كنفه سبعة فصول تدور حول أساسيات المعرفة، نظم إدارة المعرفة، تقييم وقياس رأس مال المعرفة أو رأس المال الفكري وإستراتيجية المعرفة. وسنحاول في هذا الكتاب الذي يحذو في الفصل الثالث منحى البحث التقني الخالص أن نقدم في فصوله الخمسة الأخرى مفاهيم ونظم إدارة المعرفة في ثوب قشيب ومضمون جديد وبصورة خاصة في حقول تقييم وقياس رأس المال الفكري العربي وتحليل تحديات تطبيق برامج إدارة المعرفة في البيئة العربية من خلال رؤية إستراتيجية عقلانية ناقدة.
نسأل الله جلَّ وعلا العفو والمغفرة عن كل ذنب وزلل ونعتذر سلفاً عن كل خطأ. وعزاؤنا أننا اجتهدنا ومن يجتهد فله الحق أن يخطأ أحياناً وأن يصيب أحياناً أخرى ذلك لأن كل عمل علمي هو رؤية مستقبلية للحظة من الفكر والمعرفة حتى لو جاءت هذه اللحظة بعد مخاض عسير وبحث وتنقيب امتد سنوات طويلة.
وبعد،
أسألُ الله أنْ يجزل لنا الأجر والثواب، وأنْ يتقبّل منا أحسن ما عملنا وأَنْ يتجاوز عن سيئاتنا وأَنْ يجددَ الإيمانَ في قلوبنا، وينفعنا في هذا الكتاب. اللّهمّ أَهدِ به ولهُ وأجعلهُ صدقةً جاريةً خالصةً نافعة. اللّهُمّ إِنفَع به علىِ قَدرِ الإخلاص فيهِ وهيّء لنا فرصة أخرى لنفيدَ أهلنا وأبناء أُمتنا.