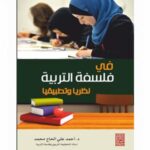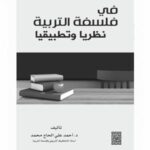بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
لعل نظرة الشكّ والريبة من جدوى الفلسفة ما زالت قائمة وسائدة في مجتمعاتنا العربية، ولا سيما في اليمن. فكثير من الأوساط الاجتماعية والفكرية ترفض حتى سماع كلمة فلسفة، وترى أنها رجس من عمل الشيطان، وما يترتب على ذلك من تكون وسط رافض للفلسفة.
في حياتنا العامة، وبخاصة بين أوساط المتعلمين والمعلمين نجد تعبيرات الرفض وعلامات النفور والمقاومة واضحة للفلسفة، وكأنها شيء لا لزوم له ولا أثـر له في حياة الناس والمجتمعات، وإن كانت موجودة فهي من اختصاص أفراد بعينهم نأوا بفكرهم عن الواقع، وراحوا يُحلِّقون بأفكارهم في متاهات لا طائل ولا فائدة منها، كنوع من الترف الفكري الزائد، بل قد تؤدي بصاحبها إلى مسٍّ من الجنون أو الجنون نفسه.
وتصورات وأحكام كهذه –لا شك- تدل على قصور فكري، وجهل بحقائق الأشياء، وطبائع الأمور، ينجم عنها قصور النظر، وتسطيح الحقائق، وفقدان المنظور الكلي لرؤية علاقات الترابط والتفاعل بين الظواهر المختلفة، والأشياء والأحداث والمواقف، وضعف فهم الأسباب والمسببات الأولى، وغير ذلك من الأمور التي تبين أنه لا حياة بشرية بدون فلسفة، وكل فرد منا له فلسفته الخاصة به، وطريقة تفلسفه التي من خلالها يتحدد منظور الفرد لعالمه، وأسلوبه لتوجيه تصرفاته، وقيمه، وأنماط سلوكه، إنهـا ذلك الشعور الصامت الذي يكون رؤيتنا لما تعنيه الحياة، وتحدد قناعتنا لما نقوم به ونمارسه في ضوء حُكمه “وليس هناك من خطأ يفوق في شناعته إنكار أهمية الفلسفة للحياة.(1)
إن طبيعة الفلسفة، تحتاج إلى جهد فكري وإعمال ذهني، بتآزر حسي نفسي، لممارسة التفكير الفلسفي، والنظر والتأمل، البحث والتقصي، وهو ما قد لا يتوافر لدى الكثيرين، أو فوق طاقة أو قدرات العامة. ولكن لا يعني ذلك أن الفلسفة لا يمارسها كل الناس، وبالتالي تكون من اختصاص أفراد بعينهم. وقد يكون الأخير صحيحاً، بحكم ما تحتاجه الفلسفة من جهد فكري؟! ولكن كل فرد يمارس الفلسفة، يمارسها حسب قدراته ومستوى تفكيره، دون أن يدرك صراحة أنه يمارسها، ويلتزم بقواعدها. أمّا من لديهم قسط وافر من التعليم الجامعي، ومن لا يريدون إجهاد أنفسهم، فإنهم إمّا أن ينـزعوا إلى إراحة العقل، والاكتفاء بالنظرة الجزئية، والتبسيط للواقع، رغم اطلاعهم على أهمية الفلسفة، أو يحاول البعض التعاطي مع الفلسفة دون وعي وفهم أكثر لوظيفة الفلسفة، فينـزعون إلى التحذلق، وصبّ الأفكار في قوالب فلسفية، كنوع من الاستعراض والرياضة الذهنية التي يندر ارتباطها بواقع الحياة.
واستتباعاً للنظرة السابقة، فإن ما ينطبق على الفلسفة عموماً، ينسحب على فلسفة التربية خصوصاً، إذ نجد إهمالاً متعمداً، وأحياناً غير متعمد لفلسفة التربية من قبل المعلمين، ومديري المدارس، والموجهين، والقيادات التربوية الأخرى، حتى يمكن القول أن فلسفة التربية تكاد تخلو من الميدان التربوي اليمني، باستثناءات محدودة، وهي بحد ذاتها تكون معزولة، ومقطوعة الصلة بغيرها من الأنشطة التعليمية.
إن فلسفة التربية ليست من مهمة جهة ما في نظام التعليم أو من مهمة أفراد أو وحدات تنفيذية ما في ميدان العمل التربوي، فهي تُهمُّ كل جهات وأطراف العمل التربوي، دون استثناء، كل يقوم بمهامه ومسئولياته في إطار عمل مشترك وموحد في ا تجاه نتائج محدودة. ومهام وجهود كل طرف تعتمد بصورة مباشرة وغير مباشرة على مهام وجهود أطراف أخرى، بحيث إذا انفصلت مهام وجهود أي طرف عن الآخر، فإن ذلك يؤثر على مهام وجهود الأطراف أخرى، بما يخل بصفة التساند والتكامل، والتناغم والانسجام بين جهات ووحدات العمل التربوي، وما يترتب على ذلك من تفكيك أجزاء النظام التعليمي، واختلال تنفيذ وظائفه، وفقدانه أهداف المجتمع، وتعثره في الوصول إلى ما يطمح إليه.
ولعلي لا أبالغ أو أتجنى إن قلت أن سبب الاختلالات الحادثة في نظام التعليم اليمني يرجع في جانب كبير منه إلى خلو ميدان التربية من فلسفة التربية، وإن وجدت فهي محصورة في ركن هامشي، يكاد يكون مقتصراً على واضعي السياسة التعليمية المتبنة في أمنيات مكتوبة، قلما تجد لها ترجمة حقيقية لدى كل مستويات التوجيه والتخطيط، والتنفيذ. وما أدل على غياب فلسفة التربية باليمن أو انفصالها عن توجيه العمل التربوي هو غياب الإجابة عن السؤال المحوري الذي تقدمه فلسفة التربية، فقط، وهو لماذا نعلم؟ وتتوقف الإجابة عن هذا السؤال والأسئلة الأخرى. من نعلم؟ كيف نعلم؟ بأي شيء نعلّم؟ وكيف نُقوّم التعليم والتعلم؟ إن فلسفة التربية هي وحدها الكفيلة بتقديم إجابات شافية وافية عن هذه الأسئلة، وغيرها، وبواسطتها (أي فلسفة التربية) تستطيع التربية أن تحقق النموذج أو الصورة التي رسمها المجتمع فيما يرغبه في أبنائه أن يكونوا، وفي نفسه أن يكون في أفضل صورة.
الملاحظ على العمل التربوي في اليمن، يجد أن هناك فلسفة تربية ما!! أو خليطاً من أفكار فلسفية غير معلنة هي التي توجه العمل التربوي، بما يؤدي إلى إيجاد النتائج الحالية التي يخرجها النظام التعليمي إلى المجتمع، ولو نفذت فلسفة التربية المعلنة، لتغيرت النتائج أو المخرجات الحالية لنظام التعليم اليمني.
ولو نظرنا إلى أخطر حلقة في تنفيذ فلسفة التربية باليمن، وهم المعلمون (رغم تأكيدنا على عدم جواز هذا الفصل) لوجدنا ما هو أدهى وأمر، حيث تكشف الخبرة الشخصية، وتحليل واقع أدائهم لمهامهم التعليمية، أن غالبيتهم لا يعرف من فلسفة التربية إلا اسمها، وإن عرفوها لا يعيرونها وزناً يذكر، ربما لاعتقادهم أنها ليست من اختصاصهم، وإذا حاول البعض الاستفادة منها، لا يفهمون كيف يطبقونها في توجيه أنشطتهم ووظائفهم أو يدركون غايتها النهائية.
إن فلسفة التربية، بحكم طبيعتها غير المرئية، وبخاصة عندما تقترب من مستوى التنفيذ، تبدو للكثير من المعلمين، ومديري المدارس وغيرهم، أنها لا تعنيهم، وليست من مهامهم، وهذا لا شك فيه- تصور خاطِئ، بل وخطير، لأن فلسفة التربية حاضرة توجه أنشطة التربية، الجزئية والكلية، وتقود كل أطراف العمل التربوي في اتساق وتوازن واستمرار. وأي قصور في هذه النظرة تنعكس سلبياً على العمل التربوي ونتائجه.
تلك إشارات خاطفة، إذا كانت تنبه إلى مخاطر تجاهل فلسفة التربية على التربية، فإنها تؤكد على أن كل أطراف العملية التربوية معنيون، ومسئولون عن تنفيذ فلسفة التربية، كل من زاوية عمله وما يخصه من مهام ووظائف.
والكتاب الحالي، هو رحلة لتقصي أبعاد أهم جانب من التربية، ربما يفوق في أهميته أي موضوع أو مكون آخر في التربية، هو فلسفة التربية، ليس لكونها تقف خلف كل أجزاء ومكونات التربية وتتغلغل فيها، وإنما أيضاً لكونها الإطار العام الذي يوجهه الفكر، ويحكم العمل التربوي في نسق كلي متكامل الأجزاء نحو غايات محددة سلفاً.. وهي رحلة تحتاج منا أن نعد أنفسنا بجد، ونتجشم متاعبها في دروب أو فصول.. يبدأ الفصل الأول بالوقوف على ماهية التربية، وإيضاح بعض المصطلحات المتداخلة. على حين يتجه الفصل الثاني نحو استعراض الأصول التي تكون التربية لبيان مواقع الأصول الفلسفية للتربية، بينما يقصد الفصل الثالث تناول الفلسفة والتربية من خلال الوقوف على معنى فلسفة ومواضيعها التي تتناولها، ثم تحديد العلاقة بين الفلسفة والتربية، تمهيداً لبيان مجال فلسفة التربية ووظائفها التي تقصد تحقيقها. هذا وتتوصل الرحلة في الفصل الرابع لتأخذ المعالجة مناحي متشعبة أكثر دقة وتصويباً لتجميع خيوط المعالم الرئيسة لفلسفة التربية، القديمة منها والحديثة التي وجهت وما زالت توجه العمل التربوي، أو تؤثر فيه بصورة أو بأخرى، وكان طبيعياً أن تنتقل المعالجة من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي لربط الفكر بالممارسة، والنظرية بالتطبيق، وذلك باتخاذ اليمن ميداناً للوقوف على تلك الروابط، حيث يتناول الفصل الأخير (أي الخامس) فلسفة المجتمع اليمني أساسًا لفلسفة تربيته، ثم استعراض مصادر فلسفة التربية في المجتمع اليمني.. أساسها ومبادئها، وكيفية توجيهها لمسارات العمل التربوي، وانتهاء هذا الفصل بنظرة سريعة نقدية لمدى تطابق الفكر مع التطبيق.
والله أسأل أن يسدد على طريق الخير خطانا
المؤلف
الدكتور/ أحمد علي الحاج محمد
أستاذ: التخطيط التربوي وفلسفة التربية
كلية التربية- جامعة صنعاء