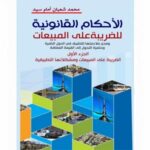مقدمــة
أولاً: أهمية البحث:
يُمثل النظام الضريبي الركيزة الأساسية للنظام الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع متحضر، فهو الأساس الذي تقوم عليه برامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
والضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة وقد ارتبط فرض الضريبة من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوي عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم، لذلك لابد من أن يكون إنشائها وتعديلها أو إلغائها بقانون، ولا يعفي أحداً من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، فإذا ما تم فرضها وكان معدلها ونطاق تطبيقها وتحديد وعائها مغايراً للأسس الموضوعة التي ينبغي أن تقوم عليها يقع فرضها مخالفاً للدستور حتى ولو كان الغرض من فرضها لمقابلة مصلحة مشروعة منها تمويل الخزانة العامة بموارد مالية حقيقية.
تعتبر ضريبة المبيعات من أقدم أنواع الضرائب الغير مباشرة في العالم، إذا عرفت دول كثيرة الضرائب السلعية، ومنها ضريبة المبيعات منذ القرن التاسع عشر، حيث كانت تعرف آنذاك بضرائب الإنتاج، ثم تطورت إلى ضرائب على الاستهلاك، والتي تطورت بدورها إلى ضرائب المبيعات حتى وصلت إلى الضريبة على القيمة المضافة، والتي أخذت بها فرنسا كأول دولة تبنت تلك الضريبة في العام 1954م منذ أن وافقت دول السوق الأوروبية المشتركة على اعتبارها المستوى الأساسي للضرائب على المبيعات، وفرضت تحصيلها من كل خاضع للضريبة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع على القيمة المضافة للسلعة.
أما مصر فقد عرفت الضرائب السلعية غير المباشرة إلى جانب الضريبة الجمركية منذ العشرينات من القرن الماضي من خلال فرض الرسوم على الإنتاج والاستهلاك على بعض السلع كالأدخنة والخمور والبنزين والكحول وغيرها، ومع زيادة حجم المجتمع وزيادة أعبائه كان ضرورياً إحداث تطور جذري للقوانين والمراسيم والقرارات التي صدرت بإخضاع بعض السلع للضرائب والرسوم لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري ولتواكب التطور العالمي، لذلك صدر القانون رقم 132 في عام 1981م بشأن الضرائب على الاستهلاك مستهدفاً تجميع كافة أنواع الرسوم في ضريبة واحدة.
ورغم أن قانون ضريبة المبيعات قد جاء أكثر جدية من قانون ضريبة الاستهلاك الملغي وأكثر إسهاماً في علاج الموازنة العامة للدولة حيث تتزايد الحصيلة الضريبية باستمرار، إلا أن التطبيق العملي قد أسفر عن وجود خلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب على المبيعات، فضلاً عن غموض بعض النصوص ومخالفة البعض الآخر لأحكام الدستور (الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون والفقرة الثانية من المادة الرابعة والمادتين 17، 35 من ذات القانون).
ومن أجل توضيح هذا الغموض الذي شاب بعض نصوص القانون حدث إفراط في إصدار القرارات والتعليمات والمنشورات والكتب الدورية التي تعالج جوانب هذا الغموض مما أدى إلى إصابة القانون نفسه بصدع تشريعي.
وبالفعل قد صدر في شأن ضريبة المبيعات منذ بداية تطبيق قانونها مما يزيد على ثلاثين قراراً وزارياً وما يزيد على 24 قراراً إدارياً، فضلاً عن صدور ما يقرب من 185 منشوراً وكتباً دورية، و50 مجموعة من التعليمات التفسيرية أصدرتها المصلحة، وبذلك تبلغ جملة القرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة بشأن تطبيق نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ما يزيد عن 300 قرار ومنشور تقريباً، بما قد يتوه البعض في الفصل بين هذا وذاك سواء المتعاملين مع المصلحة أو العاملين بها فنيين كانوا أم إداريين.
لذلك ارتأى الباحث أنه من الأهمية بمكان أن تتناول الدراسة بعض الموضوعات ذات الصلة بالتنظيم القانوني والفني لتلك الضريبة بغية تطويرها وفقاً للمتغيرات والمستجدات الدولية المعاصرة ليس هذا فحسب وإنما لأجل تلافي المشكلات والمعوقات التي تعتري طريق تطبيقها، وأملاً في التحول إلى أسلوب الضريبة على القيمة المضافة بشكل سليم على غرار ما هو معمول به في النظم الضريبية للدول المتقدمة السباقة في هذا المجال.
ثانياً: حدود البحث:
1- تناولت الدراسة موضوع الضريبة العامة على المبيعات وأحكامها القانونية لما في تلك الضريبة من أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية والمتقدمة وإن كانت بنسبة أكبر في الدول النامية حيث تعتبر مصدر هام لإيرادات تلك الدول لغزارة حصيلتها ومساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وخصوصاً في خفض معدلات التضخم والحد من عجز الموازنة العامة، وتمويل العجز عن طريق مصادر إيرادية حقيقية، كما تعد هذه الضريبة وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك وزيادة معدل الادخار والتكوين الرأسمالي فضلاً عن أنها نظام مستحدث لم يمضى على تطبيقه سوى وقت قصير، ومن ثم يكون المجال مفتوح أمام الدراسة لتناول ضريبة المبيعات في أحدث أساليب تطورها فهى تعتبر استحداثاً لضريبة الاستهلاك من حيث التطبيق والعمومية.
2- كما تناولت الدراسة ملائمة تطبيق ضريبة المبيعات بالدول النامية، تلك الدول التي تسيطر فيها الضرائب غير المباشرة حيث يتشكل الدخل القومي في أغلبه من حصيلة التجارة الخارجية، ولاسيما الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات واللتان تمثلان الجزء الأكبر، حيث تناولت بعض المشكلات التطبيقية والعملية المترتبة على تطبيق تلك الضريبة واقتراح الحلول المناسبة لها من أجل تطويرها والوصول بها إلى أحدث ما وصل إليه الفن الضريبي في مجال الضرائب غير المباشرة ألا وهو أسلوب الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية الاستفادة من ذلك الأسلوب في مناحي الحياة العملية منها التلوث البيئي وعلاج التضخم الاقتصادي وبعض المجالات الأخرى من خلال الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة والنامية التي تبنت ذلك الأسلوب في نظامها الضريبي لذلك حرصنا على أن تشتمل موضوعات الدراسة على فصل خاص بتقييم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول المتقدمة منها والنامية.
3- لقد واجهت العديد من الصعوبات أثناء سيرتي البحثية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على البيانات الإحصائية المتعلقة بالإيرادات المتحصلة بضريبة المبيعات أو القيمة المضافة وذلك لعدة اعتبارات منها أهمها:
أ- ندرة المراجع والأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية في مجال الضرائب غير مباشرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ب- إحجام بعض الدول خاصة الأوروبية والأمريكية عن الإفصاح عن البيانات الإحصائية كالإيرادات المتأتية من الضرائب المباشرة أو غير مباشرة وبصفة خاصة الضرائب على المبيعات أو القيمة المضافة حتى من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).
ج- عدم إفصاح بعض المنظمات الدولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبعض المؤسسات الأخرى الدولية المهتمة بأصول الضرائب كمنظمة (IBSD) عما تجريه من دراسات حول إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدى بعض الدول ومستقبل تطورها وما يمكن أن تواجهها من عقبات أو انتقادات وما قد يترتب عليها من مشكلات ومدى استفادة الدولة المعنية من خلال تبنيها، مما لا شك فيه أن تلك المعلومات لو كانت متاحة لكان يمكن الاسترشاد بها في مجال تحسنها عندما تناولنا موضوع حتمية التحول إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
ثالثاً: إشكالية البحث:
لقد ترتب على تطبيق قانون ضريبة المبيعات العديد من المشكلات الموضوعية منها والإجرائية، كالمشكلات المتعلقة بحد التسجيل ومدى كفايته في الوقت الحالي، والخصم الضريبي وحتمية مد نطاق الخصم إلى الخدمات، ومشكلة تعدد أسعار الضريبة والحاجة إلى توحيدها، ومردودات المبيعات والديون المعدومة ضرورة رد الضريبة التي سبق دفعها مقابل التعاملات التي لم تحصل قيمتها، وكذلك المشكلات المترتبة على قصر الفترة الضريبة والحاجة إلى مدها لتكون شهرين ميلاديين، المهلة القانونية والحاجة إلى توحيدها، العقوبات الجنائية وإعادة النظر فيها مع حتمية إلغاء العقوبة السالبة للحرية وقصرها على حالات العود في ارتكاب الجريمة ومشكلات صغار المسجلين تلك الأنشطة التي تعتبر قاطرة التنمية وتعتبر من أحد الأسباب الرئيسية في تقدم النشاط الصناعي في بعض الدول، والتأجير التمويلي وضرورة تبنيه في التشريع المصري، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى المرتبطة بالبيع بالتقسيط والدفعات المقدمة في مجال المقاولات وفرض الضريبة على شركات قطاع الدواء والسلع المستعملة والسلع الرأسمالية والضريبة الإضافية.
لذلك كان من الضروري أن نتناول لبعض تلك المشكلات واقتراح الحلول المناسبة بشأنها للعمل على تحسين كفاءة ذلك النظام الضريبي بالشكل الذي يعود بالنفع على طرفي المعادلة الضريبة الإدارة والمكلفين.
إضافة إلى ما سبق أنه لازالت ضريبة المبيعات تعاني من مشكلة رئيسية وهي ضيق نطاق فرضها وبصفة خاصة في مجال الخدمات والأنشطة المهنية حيث لا تطبق إلا على عدد محدود من الخدمات كالواردة بالجدول على سبيل الحصر بينما لا يمتد نطاقها إلى الأنشطة المهنية بكاملها. الأمر الذي يؤثر على الإيرادات المتحصلة من تلك الضريبة، لذلك وجدنا أنه من الضروري البحث عن تلك المشكلة ومحاولة وضع الحل المناسب لها من خلال الاستفادة من تشريعات الدول المتقدمة صاحبة السبق في هذا المجال من أجل النهوض بذلك الأسلوب الضريبي إلى المستوى المطلوب على غرار ضريبة القيمة المضافة المطبقة في الدول المتقدمة.
رابعاً: منهج البحث:
لما كان المنهج هو تلك الأدوات التي يستخدمها الباحث عند دراسة ظاهرة معينة- كالظاهرة موضوع دراسة وهى الأحكام القانونية للضريبة العامة على المبيعات ومدى ملائمتها للتطبيق في الدول النامية…. إلخ.
لذلك يجب أن تكون الأدوات المستخدمة متفقة وموضوع الدراسة، عليه فقد اعتمد في دراستنا على المنهج الاستقرائي، ذلك المنهج الذي يقوم على عرض النصوص الدستورية والقانونية والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص وتحليلها بشكل مختصر، ثم تعرض في البحث لبعض المشكلات الموضوعية والإجرائية المترتبة على تطبيق القانون واقتراح الحلول المناسبة لها اعتماداً على المنهج المقارن المبني على التتابع والتسلسل المنطقي للبحث العلمي من خلال عرض المسألة أو المشكلة المراد بحثها المنبثقة عن القانون الوطني، ومقارنتها بما هو متبع بالنظم الضريبية المقارنة التي سبقتنا في هذا المجال واقتراح ما هو أفضل وبما يتفق وطبيعة مجتمعنا الضريبي.
خامساً: خطة البحث:
تشتمل خطة البحث على النحو التالي:
الكتاب الأول : الأحكام القانونية للضريبة العامة على المبيعات.
الباب الأول : التنظيم القانوني والدستوري للضريبة.
الباب الثاني : التنظيم الفني للضريبة.